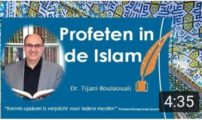»
ساحة للرأي »
هل نحن أمام مشهد إبداعي مهجري، أم أمام حالة ارتزاق لا غير؟
المتأمل في المشهد الإبداعي عموما من شعره ونثره وفنه بكل تفرعاته الموسيقية والتشكيلية والمسرحية وغيرها، وإعلامه الرسمي وغير الرسمي (إلا من رحم ربك)، وخاصة منه الطارئ بعد فتح المجال الإليكتروني من مواقع وقنوات وإذاعات.. لابد وأن يصاب بالصدمة بشرط أن يكون له ضمير حي وروح ترفرف في سماوات المثل والقيم. فكما جاء في الحديث الشريف إنما الناس كالإبلال مائة لا تكاد تجد فيها راحلة، المنابر كآلاف مؤلفة لا تكاد تجد فيها ما يبل ريقك ويهز إحساسك ويضيف إليك لمسة جمال.
ما زلت أذكر أني قبيل سنوات وكنت بعد جديدا على الساحة الإبداعية ببروكسل، حين يخطئ أحدهم ويرسل لي دعوة حضور لمنتدى ما أو أمسية، أتردد ألف مرة قبل تلبية الدعوة أو إهمالها، فكنت إذا أرغمت نفسي ونقلت جسدي لا غير دونا عن روحي إلى أحد الكراسي المبثوثة أمام منبر مترهل بخطابة من استقام عليه وهو الخارج عن زمن الشعر والإبداع، أكاد أنفجر من شدة الغيظ والشفقة على مآل الوضع المزري في أوروبا، بلجيكا وعاصمتها بروكسل كنموذج، فإذا أُتخمت من قيئ الرداءة على مسامعي انسحبت من غير أن يشعر بي أحد ولم أظفر بما يشبع ظمئي للابتكار، أعود إلى مكتبتي المتواضعة لأتصفح تجربة شعراء المهجر وأدبائها القدامى، من مثل إيليا أبي ماضي وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وغيرهم، ومن أجمل بل وأغرب المصادفات أن معظم رواد المدرسة المهجرية كانوا من العرب النصارى، لكنهم عبروا عن النفس البشرية المرهفة على اختلاف معتقداتها ومذاهبها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، فصوت الفطرة في النفوس واحد. بل كان صوتهم وما زال أبلغ في النفوس من كثير من المتشدقين بدين الله البريء من تحجيمهم له، الساعين بإسقاط مفهومهم لا مفهومه هو لكل إبداع، حتى لم تعد (غيرتهم) عليه إلا تجارة بآياته ومورد رزق لهم وسبيلا لجمع المال وعدّه.
اختلط الحابل بالنابل، وتشابكت مصالح الإعلام الضال (وليس الظال وقد التبس على كثير من إعلاميي الاضطرار التمييز بين الضاد والظاء، كما بين الدال والذال)، ونتساءل معا: كيف وصلت إلينا إبداعات هؤلاء وانتشرت في العالم العربي بل والإنساني برمته رغم عدم وفرة المنابر الصحفية والإعلامية حينها وانعدام التواصل السريع بل الآني مثلما هو الحال في زمننا هذا، ولماذا لا يرتقي الإعلام (إعلام فرض الواقع الحالي) إلى الرقي بنقل الكلمة التي تستحق أن تبلّغ، وتخرج من وحل تغطيتها المتواضعة جدا، وترقى بقلمها الافتراضي عن عقلية التصنيف والتشهير وتصفية الحسابات.
لكن -ونفتح قوسا مع الإعلام هنا أو ما يطلق عليه تجاوزا إعلاما-كيف يكون بإمكان فاقد الشيء أن يعطيه، وكيف لمن يحتاج إلى القراءة بعدُ أولا أن يكتب، وكيف يمكن لمن لا نظرة له على حقائق الأمور أن يخوض فيها؟؟؟
إذا كان الواقع الافتراضي قد خلق كيانات وهمية تعجب بنفسها فقط لأعداد الجمجمات (نسبة إلى J’aime) والتعليقات والمتابعات، والتي لم يعد خافيا على أحد أنها تشترى بالعملة الصعبة لإيهام المتلقي غير الحازم لأمره أنها قد أصبحت ذات شأن ورنة وشنة، كذبا منها على نفسها ونفخا في أناها الفارغة من كل إدراك لمهنة الصحافة، وتشدقها بالمبدئية والنزاهة وهي في واقع الحال “مواقع تدوين مرتزقة”، تقلب الحقائق بما يتماشى ويتلاءم مع، ليس توجهات بل مصالح (غالبا ما تكون شخصية) لمن يدعمها ويلبي تعطشها للمال لا غير، من رجال أعمال وسياسيين من الدرجة الثانية وجهات دولية وشبه دولية من منظمات مشبوهة وغيرها تتعارض رؤاها مع رؤى الدولة التي ينحدرون منها وغالبا ما يكون في نفس هذه الجهات الداعمة نية تكريس انفصال جغرافي عن البلد الأم أو انفصال إثني أو لغوي أو مناطقي.
كيف يمكن لصحافة تنحدر من رؤية إثنية ومساحة جغرافية وعقلية متأزمة لا تعبر حتى عن انتمائها لوطن ككل، أن تصبح لسانا لكل من ينتمي لذلك الوطن، وحين تنضاف على هذه التركيبة اللعينة خلفية فكر متطرف بغيض، (يساريا كان أو يمينيا أو إثنيا أو دينيا). فلا يبقى أمامنا إلا أن نقول عن نزاهة الصحافة: السلام. ربما كنا أمام إعلام الطبل، صوت دوي لا يعكس إلا الفراغ المملوء بالهواء داخله.
ولنعرج قليلا على ظاهرة الجمعيات “الثقافية” والتي من أسمائها وصفاتها العلا (أنها جمعيات بدون هدف ربحي)، أي ليست تكتل ريع، لنصطدم بتهافت الباحثين عن الثروة من نافذة الثقافة ومعظمهم لا يبث للثقافة لا من قريب ولا من بعيد، حتى انتشرت هذه الجمعيات مثل الفطر تحت مسميات عدة من قبيل الفن، الإبداع، التعايش، حوار شمال جنوب، معاهد لست أدري ماذا إلخ، وكلها في واقع الأمر إلا من رحم ربك ( وقد نتناولها بالإسم والتدقيق والتمحيص في مقالات قادمة)، كيانات تجارية وهمية تتاجر بثغرات قانونية سواء في القانون البلجيكي أو القانون المغربي (تجربة دار الثقافات المغربية الفلامانية: داركم مثلا)، وتكلف ميزانية الدولتين مبالغ طائلة تنتهي في جيوب أشخاص وجهات “ما”، لكنها لا تنتهي أبدا إلى إنتاج فعل ثقافي يعبر عن رصيد حضاري ومعرفي ما، يخص منحدرين من بلد عريق كالمغرب ضارب جذوره في عمق الثقافة والتاريخ والحضارة، أو بلد آخر شقيق !!!
بعض من هذه الجمعيات التي من المفترض أن تكون واجهة لأمة عريقة لم تنتج في الواقع إلا انقسامات في صفوف الجالية المغربية والعربية، وانتقلت من حقبة تأسيس المساجد ومدارس تعليم اللغة العربية التي بارت تجارتها ولم تُؤت بنتائج إيجابية أبدا، إلى الميدان الثقافي والفني وهو ميدان يفضح فيه صاحبه من أول لحظة، لأن الإبداع بكل صوره عملية ذهنية شخصية مركبة. فما يستطيع الإنسان أن يكون شاعرا إذا لم تتوفر فيه الموهبة التي تصقلها التجربة والممارسة وسعة الاطلاع، ولا يستطيع أن يكون فنانا إذا لم تتوفر فيه شروط معينة، ولا مغنيا مثلا إذا لم يكن ذا صوت جميل وعذب (إلا إذا كانت له أو “لها” مؤهلات وكفاءات” أخرى غير الصوت!). غير أن الواقع الحالي يشهد على كل ذلك: كثر المبدعون والمتاجرون به، وانتفى الإبداع.
وقد يصبح العمل الجمعوي مجرد وسيلة تكسب بعد أن اجتمعت في أوروبا كيانات هشة تركت أوطانها في موجة هجرة جديدة لأسباب أمنية أو غيرها، لم تجد وسيلة للكسب غيره. وهي الحديثة الطارئة على الساحة، وهي الكيانات التي تعتمد أبسط الطرق لاختصار المسافات، ألا وهي النسخ واللصق، والتملق لكل جهة داعمة مهما كانت تلك الجهة، ومهما كان عداؤها سافرا لكل ما هو أصيل وجميل، سواء باسم العولمة أو تحت شعار الحداثة والتجديد، دون أن تصرح عن أهدافها السافرة المتمثلة في تكريس الرداءة من خلال تكتيلها مرحليا، لتوظيفها في أجندات خطيرة، واستغلالها في تصفية حسابات قديمة لا علم لهذه الوافدة حديثا بها، ومحاربة وتحطيم الجهود الصادقة التي تحاول جاهدة الإسهام بما يليق بوجه جاليه تجاوزت النصف قرن من الهجرة وما زالت لم تبلور كيانا ثقافيا إبداعيا صلبا، سوى أنها في ذات الوقت معادلة صعبة لا يمكن تجاوزها بسهولة.
فماذا لو عادت معظم الجمعيات “الفاعلة في الحقل الثقافي” الملغم بشتى النوايا والأهداف والمصالح، إلى ضمير الحق وسعة الجمال لتعي دورها التاريخي، فتتوب عن “جوعها وظمئها للريع”، وتخرج من دائرة العفوية والارتجالية والعشوائية، وتضع يدها في يد غيرها (كل فيما يبدعه ويتخصص فيه على الأقل التزاما بما هو في ميثاق تأسيسه)، لتتنوع المساهمات والمشاركات، لتفعيل الحراك الثقافي (المجري خصوصا)، بعيدا عن “الشللية” والانطواء على “القطيع المشابه”، الذي لا هم له إلا ملء حويصلته. لنرقَ إلى مستوى الإبداع الحق، فلسنا مرتزقة !!!
وفي المقابل ماذا لو استمر الوضع على ما هو من تمييع، هل سنشهد تقنينا جديدا للعمل الثقافي ببلجيكا خاصة وأوروبا عامة وإعادة نظر في قانون الجمعيات، وهل ستطالب هذه الجمعيات بتقديم أوراق نشاطاتها ووائل حصولها على الدعم (الريع) لجهات لا شك ستحاسبها كما تحاسب الشركات، فلا بد آجلا أو عاجلا من مراقبة مالية للجمعيات، وتفتيشات ممنهجة متخصصة من قبل الدولة المانحة للدعم أو المنظمات أو الجهات، أو من يقوم مقامها، حتى لا يفلت أحد من العقاب ووضع حد للارتزاق والابتزاز؟ أم سيستمر الحال على ما هو عليه حتى تموت موتتها الطبيعية، وتنهار ديكتاتورياتها الوهمية، وتصل على النتيجة المحتومة بفصل جشع الدخلاء والوصوليين والمشبوهين الذين أسقطوا فلسفة التطوع وخدمة الصالح العام؟
نحن بحاجة إلى عمل مدني موازي متطور ومسؤول، لكن غير ذلك المبني على الابتزاز والارتزاق والتحايل على القانون.
-يتبع-