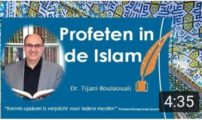»
الاخبار المهمة »
الدكتور عبد الله بوصوف:الهجرة ثروة لاماديّة لدول الاستقبال .. فرنسا نموذجا .
لـيس الإصرار على إفشاء قواسم العيش المشترك أو المبادئ الكونية للتعايش، والإلحاح على التذكير بالقيمة المضافة للهجرة في بلدان الاستقبال، خاصة بالدول الغربية، مجرد محاولات يائسة أو محاولة لثقب الماء، بل هي حقائـق تصرخ بهـا صفحات مضيئة من التاريخ الإنساني وتمثل الوجه المشرق لظاهرة الهجرة والترحال.
وحتى لا نُـتهم بالعصبية إلى أهلنا وعدم الملل من التذكير بأفضال كل الرحالة العظام، أمثال ابن بطوطة الـذي قـرب عوالـم الـصين كـان يجهلها الـعـالـم عـن هـذا الـبـلـد، ونـقل المعارف عن الكنيسة القبطية بمصر إلى المغرب، والحسن الوزان، الـذي درًس اللغـة العربية بالفاتيكان، وغيرهم من الرحالة المغاربة، سـواء في طريقهم إلى مكة أو المدينـة المنورة أو بيت المقدس، كمحمد العبدري الحيحي 1289 وعبد الله بن محمد العياشي 1663… فـإننـا الـيـوم نزداد يـقينـا، ونقـولها وبالصوت العالي وعلى رؤوس الأشهاد، بأن الهجرة قيمة مضافة لكـل مجتمعات دول الاستقبال؛ وهي رافعـة للـقيم الكـونية للعيـش، بل تمثل نوعا من الثروة اللامادية لتلك المجتمعات، إذ استعصى على كل صانعي الكـراهيـة وزراعي الخـوف الـنيل مـن تـاريخها ومن تراثها الإنسـاني مهما اختلفنا أو اتفقنا مع كـل توجهاتها الفكرية والفلسفية…
الكُتاب والأدباء والفنانون يعيشون حتى بعد مماتهم عند كل قـراءة لأحد نصوصهم أو أفكارهم. كما أن أغلب الأموات يسكتون لأنهم قالوا كل شي في حياتهم، إلا الشعراء والأدباء فيستمرون في الحديث والمساهمة في النقاش عبر كلماتهم وأفكارهم؛ وهذا بالضبط ما جاء به الكاتب الهولندي “كـيس نُوتـيـبُـوم” في كتابه “القبور، قبور الشعراء والمفكرين” سنة 2007.
لهذا لم تستطـع كـتيبة صناع الخوف ومحترفي تأجيج الاحتقان الاجتماعي والديني بفرنسا مثـلا، كإيـريك زمور أو ميشيل هويلبيك وجيل كيبيل وفينكيلغوت، النيل من رصيد المجتمع الفرنسي الإنساني، والذي ساهـم في بنائه أيضا المهاجرون وجنود المستعمرات الصباحيين و”الكـُـوم” وأيضا اللاجئون وغيـرهـم…
ويكفي أن نتصفح لائحة أسماء أدباء وفلاسفة وفنانين احتلوا شوارع وأزقة باريس، عاصمة الأنوار، مثل زنقة “دي لامبير” و”سان جيرمان دُوبْـر” وشارع “مونبارناس” الشهير، و”مونمارتر” … حيث عاشت أسماء بيكاسو وخوان ميرو وسالفادور دالي ومانويل أورتيز واندريه جيد؛ وغيرهم…
لقد كان كل من فيليب ساوْبُـولْت والـسـيـد فـانُـو وغيرهما يعـرفون شـوبان وباخ في شوارع باريس، مـدينـة حقـوق الإنسـان التي تتمتع بجرعة كبيرة من الحرية جعلتها قبلة لحوالي 30 ألف لاجئ سنة 1935، وأغلبهم فنانون وأدباء صنعوا من المقاهي الأدبيـة بباريس، “كمقهى دو فلور” و”مقهى لاروتـونـد” و”براسري ليب” و”كروز دي ليلاس”، وغيرها، منصات فنية وفكرية وفلسفية لكبار الفلاسفة، من طينة جون بول سارتر ورفيقته الشاعرة والأدبيـة سيمون دو بوفار، وألبير كامو ورايموند كوينـز، والشعراء تورسكي وكاميل براين ودوبومونت ورسامون كـديسيُـو ووُول…بـل حتى بعد الحرب العالمية الثانية التحق بباريس جنود أمريكيون وأدباء كإرنست همنغواي وفنانون من أجل البحث عن الإلهـام أو نـشر موسيقى الجاز الأمريكيـة، كدوك اني لغتـون أو بوريس فيان…
كل هذه القامات الفكرية والفلسفية والفنية ساهمت في إغناء وتغذيـة مخيال المجتمع الفرنسي وخلقت لنفسها مدارس فكرية لازالت تُـناقش أفكارها إلى حد الآن، وتُعتمد كتـراث إنسـاني عـالمي، لأن أغلب هؤلاء المثقفـين سكنوا العالـم من خلال اللجوء من كل حدب إلى مدينة باريس مدينة الأنوار؛ وقد أسسوا لأنفسهم مدارس فكرية ومناخ نقـاش عام ومفتـوح، وساهموا في تأسيس مجلات وجرائد وتنشيط المسرح والفـن التشكيلي والسينما والغناء… وجعلوا مـن باريس وأزقتها مزارا لعشاق الحرية والإبـداع والـفـن، وساهموا أيضا في صناعة الـرأي العـام وتـوجيهه، لـهـذا استحقت لقب “عاصمة الأنوار”.
إن احتضان بـاريس لكل هذه القامات العالمية في الفن والفلسفة والآداب كان من أعظم الاستثمارات التي شهدتها فـرنـسـا وساهمت في تكوين نخبها والتأثير على مسارات الكثير من مفكريها وسياسيها… لكل هــذا يُـمكن اعتبـار إريك زمور وميشيـل هـويلبيـك ومشتقاتهما أقزاما فكرية فقط هدفها هو تمزيق المشترك الإنساني والتشكيك في العمق الكوني والقيمة المضافة للمهاجرين، وظواهر صوتية ارتبطت ببرامج لتيارات سياسية مُتطرفة لا تخدم المجتمعات المتعددة الثقافات، لذلك من المستبعد أن يجدوا لهم مكانا في “مقبرة العظماء” بمونبـارناس الباريسية حيـث تستريح رُفـات الفلاسفة والمفكرين والفنانين!
وعلى جسر نهر السين نفسه، حيث أغْـرق محسوبون على اليمين المتطرف المهاجـر المغربي المرحوم ابراهيم بوعرام في عيـد العُمـال مـن سنة 1995، هناك نجـد مساحـات لـبـيـع الكتـب القديمـة ونفائس الـفـكـر العالمـي الـتي ساهم بهـا سكـان “مقبرة العظماء” بمونبارناس.
وفي مونبرناس أيضا نلمس ذكرى أحـداث مـأساويـة وعنصريـة عانى منها المهاجـرون تـضييقـا وقـتـلا وعُـنْـفـا، مثل أحداث 17 أكتوبر 1961 عندما هاجمت الشرطة الفرنسية بأمـر من رئيسها “موريس بابون” مسيرة سلمية راح ضحيتها آلاف من الجزائريين والمغاربة الذين خرجوا احتجاجا على قرار حظر التجول الذي استهدفهم دون غيرهم…!
لكن القـوى الـحية بفرنسا ونخبة المثقفين وأطيافا سياسية ونقابية حاولت جبر الضرر من خلال اعترافها العلني بعنصرية الحادثيْـن، وذلك بتنصيب لـوحتيْـن تـذكاريتيْـن بجانب نهر الـسين بمونبارناس، كما تفاعل مع هذا الحدث عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي في رائعته «مونبرناس» ومن كلماتها:
في مونبارناس مات خويا يا بُـويا…
برصاص قناص عنصري يا بُـويا..
لكن مونبارناس هي أيضا الحي اللاتيني وحي الفن والآداب والفلسفة وشغب الفضول المعرفي الذي تغلب على شغـب حليقي الرؤوس والتيارات المتطرفة سواء السياسية أو الفكرية.
وليـست باريس وحدها، ففي كل تـراب فـرنسا هناك بصمات مشرقة للمهاجرين واللاجئين الذين ساهموا في بناء مجدها وإشعاعها المعرفي أو العمراني، ولن تستطيع حفنة من المتطرفين أن تلطخ المخيال الجماعي الفرنسي بمجموعة من الأحقاد الشخصية؛ بل سيستمر رواد المقاهي الأدبيـة في مونبارناس بطلـب صحن اللحـم المسمى “همنغواي”. كما ستستمر “مقبرة العظماء” بمونبارناس شاهـدة على أعظـم استثمـار معرفي وثقافي وفكري قـامت به فـرنـسـا عنـدما استقبلت مهاجرين ولاجئين من مختلف بلدان العالم في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي…
فـرنسا الحامية لمبدأ التعايش المشترك، وفصل الدين عن الـدولـة، أعطت إشارات إيجابية للمصالحة مع الذاكرة الجماعية والعيش المشترك، وحددت اختيـارها المجتمعي من خلال مبادرات اعتبرت عربونا سياسيا وإنسانيا من الساكن الجديد لـقصر الإيليزي إيمانويل ماكرون (الرئيس رقم 8 في الجمهورية الخامسة منذ نشأتها من طرف الجنرال ديغول سنة 1958) حين وضع إكليلا من الزهور على جسر نهر السين في ذكرى قتـل المهاجر المغربي إبراهيم بوعرام في مـاي 1995.. ولتزداد الصورة وضوحا؛ يـوم تسليم السلط الرئاسية في 14 ماي 2017 بينه وبين الرئيس السابق فرونسوا هولاند، بحضور العديد من ممثلي الجاليات المسلمة والعديد من الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية؛ وهـو دليـل اعتـراف جـديـد بالقيمة المضافة لكل المهاجرين، وأنهم عامل للاستقرار والسلم الاجتماعي ورافعـة للتقدم والازدهار…